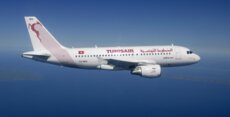التنمية مفهوم نهضوي قديم، إنطلق في القرن الرابع عشر، مع فكر إبن خلدون، وأبحاثه حول مقومات العمران.
أما في الأزمنة الحديثة، فهو مشتق من فعل "نَمَى" و "ينمو" وكان يعبّر عنه بادئ الأمر "بالنمو" الذي كان ينحصر في نشاطٍ معيَّن، وقطاع محدود، فكان يقال مثلاً: النمو الصناعي، والنمو الزراعي، والنمو الثقافي، والنمو التعليمي إلخ ... إلى أن أصبح اليوم شاملاً جميع الأنشطة، فبات يعرف بالتنمية التي باتت تشمل جميع القطاعات: الصناعية، والزراعية، والسياحية، والثقافية والتعليمية والبيئية إلخ...
ولكن التنمية بهذا المفهوم، وإن كانت تتضمَّن العديد من الإصلاحات والتغييرات، التي تتمّ في جميع القطاعات لصالح كل فئات، وأفراد المجتمع، فإنها كانت تشير، حتى بداية العقد الثامن من القرن الماضي، إلى تقدّم هذه القطاعات في وقت معيَّن وفي منطقة أو بلدٍ محدد.
أما اليوم، فإن التجارب التنموية، ونوعية الإنجازات المحققة، ومواقع الضعف والخلل، يتعيَّن النظر إليها ضمن إطار ما يسمى بالتنمية القابلة للديمومة، ويعبِّر عنها بالتنمية المستدامة، (sustainable development – développement durable).
وهكذا، باتت المقاربة الجديدة تتبلور أكثر فأكثر، فتدعو إلى الإرتكاز، لا على السياسات الإقتصادية والإجتماعية والفكرية والسياسية وحسب،...، ولكن أيضاً على احترام "البيئة" ومخزون الموارد الطبيعية في رسم، وتحديد تلك السياسات، وهي مقاربة غنيّة، تصلح لتكون قاعدة خصبةً "للحوار البنّاء" بين صانعي القرار، وهيئات المجتمع المدني، التي أخذت تنمو، لا في الدول المتقدمة وحسب، بل وأيضاً، وان بنسبة أقلّ، في الدول النامية، ومنها الدول العربية.
ولا شك بأن هذه المقارنة الجديدة تفتح آفاقاً جديدة في إمكانية تحسين مرتكزات التنمية التقليدية، والحفاظ على حقّ الأجيال المتوالية في المستقبل، بالإستفادة ممّا أنجزه الآباء والأجداد الذين سبقوهم.
إن مضامين التنمية "المستدامة" القائمة على هذه المقاربة، والتي تأخذ بالإعتبار إستمرار الإنجازات التي تساهم في تحسين الأوضاع الحالية، ولا تهمل حقوق الأجيال الطالعة، هي من الصعوبة بمكان، بحيث أن صانعي القرار اليوم، يشعرون بضرورة تقوية الوسائل الفكرية التي يمكن من خلالها تأمين وتحسين مرتكزات التنمية الشاملة للمستقبل ...
سنستعرض فيما يلي، أسباب بروز التنمية المستدامة ومراحل تطور مضامينها، وما تفرع ويتفرَّع عنها من مبادئ مختلفة يقتضي بأن ترتكز عليها آليات التنمية الجديدة، بغية تصحيح الإعوجاج، والإختلال في الوضع الإقتصادي العالمي. وبخاصة لجهة ضرورة الحفاظ على البيئة، واحترام وحماية الرأسمال البشري، الذي هو محور التنمية الإنسانية بصورة عامة، وعلى صعيد المجتمعات النامية ومنها لبنان، بصورة خاصة ...
وبعد ذلك، سنشير الى مواقع الخلل والإختناق العديدة، التي تتميّز بها الإقتصادات في الدول النامية، والتي لا بد من إزالتها من خلال السياسات المختلفة، والمؤدّية الى تأسيس مقومات التنمية المستدامة في هذه الإقتصادات.
ونختم بعد ذلك، بما يمكن، ويجب أن تتجه إليه السياسات الإقتصادية والإجتماعية الكليّة لتغيير المسار التنموي الحالي، الذي يتعارض في بعض مكوّناته مع مقومات الصمود والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الهامة في النظام الجديد، (والذي لا يؤمن التعاصد الإجتماعي) وتوظيف الكفاءَة في الإداء الإقتصادي والإجتماعي، بحيث تساهم كل الفئات الإجتماعية من آليات التنمية، وتحصل على حصةٍ عادلة من ثمار التقدّم العلمي، والتطور الإقتصادي والرقيّ الإجتماعي.
أن مفهوم التنمية المستدامة بدأ خلال العقد الثامن من القرن الماضي، نتيجة الإهتمام بالحفاظ على البيئة. وبخاصة من خلال تقارير "نادي روما"، خلال السبعينات حول ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنضوب، وحول التوازنات الجوهرية في الأنظمة البيئية (écosystèmes)، ونتيجة لتعثر الكثير من السياسات التنموية التي أدّت الى تفاقم المديونية الخارجية، وتردّي الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتوسع الفروقات الإجتماعية، وإرتفاع نسبة المجاعة، أو تراجع التغذية، نوعاً وكميّة بالرغم من الإستثمارات التي تمّت في العقود الثلاثة الأخيرة في القرن الماضي.
وهكذا باتت السياسات الإنمائية تستوجب الإستفادة من التكامل فيما بينها بصورة عادلة، مركزة على قضايا الإنسان وأوضاعه الشخصية والثقافية والسياسية، على خلاف ما كان يجري في السابق من خلال التركيز على التنمية المالية، وزيادة معدلات الإستثمار والنمو الإقتصادي السنوي، ورفع مستوى الإستهلاك من المنتجات الصناعية الحديثة.
وعليه، فإن السياسة الإنمائية المستدامة هي أوسع أفقاً من السياسة التنموية القديمة، ليس فقط بما لها من مضامين شاملة، بل لأنها أيضاً تتصف بالإستمرارية والعدالة، وبل لأنها تؤمن الامتداد، والترابط بين الأجيال، بتوفيرها ما تحتاجه من المخزونات الكافية من الموارد الطبيعية. وسط بيئة نظيفة بريئة من الملوّثات على تنوعها، ومتميّزة بالمستويات العلمية المتقدمة التي تضمن لها الإستمرار، بعيداً عن النكسات، والمتاعب، والتعاسة الماديّة والثقافية والروحيّة.
وكل ذلك لا يمكن بأن يتحقق إلاّ من خلال الحوار الدائم، والشفاف، والديمقراطي، والخاضع للمساءلة بين الحاكم والمحكوم، أي بين صانعي القرار الحكومي، ومكوّنات المجتمع المدني، من جهة ثانية، ضمن إطار مؤسساتيّ سليم، يرضي هذه المكوّنات ويقيها من الظلامة، من خلال تبادل الرأي. وتوفير المعطيات الدقيقة، لإجراء الحوار الصادق المؤدي إلى إتخاذ القرارات التنمويّة المناسبة.
إن دول العالم الثالث، ومنها لبنان، لم تفلح حتى الآن في الحصول على مواصفات التنمية المستدامة، ما عرّضها لتقهقر أوضاع البيئة، وإرتفاع درجة التلوث والإساءة للأجيال الحاضرة والمستقبلة، ما دعا المؤسسات الدولية وكبار العلماء، والشخصيات المهتمة بالشأن الإقتصادي الى وضع تقارير كان لها مدى بعيد وفي غاية الأهميّة، على الصعيد العالمي، منذ سنة 1976، عبر السعي لإنشاء نظام الدولي جديد يصبح فيه للمجتمع حق غير قابل للتنازل عنه، في حياة لائقة ومريحة. محدداً المشاكل التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة، عبر لفت النظر غلى مجموعة من أسباب هذه المشاكل، وهي الإنفاق المتمادي للسباق على التسلّح، وارتفاع عدد الفقراء في العالم، وسط سوء توزيع المواد الغذائية، وازدياد وتيرة الهجرة الريفية، وتسببها بالفروقات في المستويات المعيشية، وأزمة النظام النقدي المعتمد العملة الأميركية، وعجز ميزان المدفوعات الأميركي، وأزمة الموارد الطبيعية والطاقة، والنقص في كمية المياه العذبة، وغياب تنظيم استغلال موارد البحار، وتنظيم استغلال الفضاء، وتصاعد الأزمة البيئية، وعدم المساواة في إنتشار العلوم والتكنولوجيا، وإنعدام المساواة في التوعية بين المجتمعات، وتسخير المنظمات الدولية في خدمة الدول المتقدمة إلخ ...
وفي سنة 1983، وضعت مجموعة من الشخصيات الدولية المرموقة برئاسة المستشار الألماني "ويلي براندت" تقريراً ندّد فيه بمستوى نفقات التسلح، وما يمثله من خطر على الإنسانية.
وفي سنة 1987، صدر تقرير "اللجنة العالمية المعنيَّة بالبيئة والتنمية" حول المستقبل المشترك للإنسانية، أبرز مفهوم التنمية المستدامة، مشدداً على حاجات الأجيال في المستقبل، وعلى تحسين مستوى التكنولوجيا، والتنظيم الإجتماعي، وأثرهما على الموارد البيئية وعلى محاربة الفقر، ومواكبته للكوارث البيئية.
وفي سنة 1989، إتّخذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) قرار عقبه سنة 1990 قرار آخر عن الأمم المتحدة شدّد كلاهما على التركيز على المجالات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وضرورة تدعيم العدالة على المستوى الدولي، وبخاصة داخل الدول النامية والتأكيد على عدم الإستغلال العشوائي للموارد الطبيعية، وبخاصة موارد الطاقة إلى أن إنعفدت سنة 1992 في مدينة "ريو دو جبيرو"، في البرازيل، قمة جمعت رؤساء دول العالم التي وضعت ما عرف "بميثاق الأرض" الذي تضمّن 27 مبدأ لإدارة البيئة وجدولاً تفصيلياً لأعمال القرن الواحد والعشرين (Agenda 21) الذي أصبح المرجع الرئيسي للتنمية المستدامة على الصعيد البيئي في العالم وبذلك أصبح مفهوم التنمية المستدامة مفهوماً مركزياًليس فقط في مجال الشؤون البيئية، وإنما أيضاً في جميع أدبيّات التنمية في ميادين الزراعة والصناعة والإبتكار العلمي والتكنولوجي، وشؤون الفقر المتلازم مع البيئة.
والملفت أن التنمية المستدامة تتضمّن إتجاهات واضحة في تطوير المهارات لتنظيم الوحدات الإنتاجية وتنظيم إدارتها في مختلف القطاعات وتنظيم سوق العمالة، وتجهيز الموارد والطاقات البشرية، وقيام السياسات الإقتصادية الكليّة عبر تأمين المشاركة الواسعة وتزويد الأفراد بالموارد والعلوم والمهارات اللازمة.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الإتجاهات في مفهوم التنمية المستدامة تتناقض، أو على الأقل تختلف مع النظريات الليبرالية الجديدة، الواعية لسلطة السوق بصورة مطلقة، وعدم تدخل الدولة في العلاقات الإقتصادية والإجتماعية المحلية والدولية، من خلال تنظيم ما عرف بالضبط النقدي (régulation monétaire)، وقد أشارت تقارير التنمية البشرية بأن سياسات الإنتقال من الإقتصاد الموجّه الى إقتصاد السوق، أدت الى الصعوبات والكوارث الإجتماعية، واشتداد ظاهرة الفقر لدى فئات واسعة من السكان. وقد أشار التقرير سنة 1996 الى أن الرأي السليم يتمثل في "أن التوزيع المنصف للموارد العامة والخاصة هو الذي يعزز احتمالات تحقيق من المزيد من النمو". وان هنالك ترابطاً إيجابياً بين النمو الإقتصادي والمساواة في الدخل (التي تمثلها حصة أفقر السكان: 60%). وقد كانت اليابان، وجنوب آسيا، وماليزيا، الدول الرائدة في تحقيق هذا الشكل من أشكال التنمية المنصفة. هذه هي التنمية المستدامة.
ولكن ما هي المبادئ التي تستند إليها؟
إن مقومات التنمية المستدامة تفترض توفر عدد من المبادئ الرئيسية وأهمها العدالة، والانصاف، والمشاركة في توزيع المسؤوليات والموارد، وذلك ما يتّفق مع النظرية التي نادى بها العاِلم الأميركي جون رولس (John Rawls)، والتي تدعو إلى تنظيم المجتمع على أساس التوازن الملائم في ثروات البلاد، وهو تنظيم يلغي معاناة فئة من المجتمع، موفراً بحبوحة أكبر للمجتمع ككل، أي بين الذين يمتلكون الثروات، والذين لا يمتلكونها، وهو ما يتفق مع التيارات الفلسفيّة اليونانية القديمة الداعية إلى مبدأ الإنصاف والعدالة، وهما شرطان لإستقامة العلاقات بين الأشخاص، ولتحقيق التناسق بين أعضاء المجتمع، وفي ذلك ضمانة مؤكدة لإستمرارية النظام الإقتصاديي والسياسي والإجتماعي على المدى الطويل، أي "التنمية المستدامة" وفي ذلك ما يتفق مع ما يؤكده العالم "مارسو كده"، العالم الأميركي الشهير في التاريخ والعلوم السياسية: "بما أن المتحمسين للعولمة يركّزون، بصورة مطلقة، على آثارها في المجتمعات الغنية، فإنهم يهمشون بذلك 80% من سكان العالم، وهو ما يتعارض مع ما يؤكده، وينادي به المجتمع حول "نادي المواطنية الدولية" على اعتباره الشعار الذي يدعون اليه مع بداية القرن الواحد والعشرين، والذي يفترض من جميع الدول الغنية بصورة خاصة، بأن تدفع ثمناً مرتفعاً لإنجازه من خلال إعادة صياغة المهارات القومية، والبنى التحتية، وإزالة العوائد القديمة والمصالح المكتسبة التي تتعارض مع الإنصاف والعدالة والمساواة ...
وإلى جانب مبدأ العدالة والإنصاف هنالك مبادئ اخرى، ومنها تمكين جميع مكونات المجتمع، وبخاصة المرأة من الحصول على حق المشاركة في الحياة الإقتصادية، أي في قرارات والآليات التي توجه مصير جميج هذه المكونات، على أن تصاغ بمعرفتها، فتؤخذ بالإعتبار حاجاتها وهمومها، والمشاكل التي تواجهها. وكل ذلك يحقق مبدأ الحاكمية، أي "حسن الإدارة" (Bonne gouvernance) اي جدية اسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع، على أساس الحوار بين الحاكم والمحكوم، وفي وجود أدوات للمراقبة والمحاسبة، وآليات سليمة لإتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى مبدأ المساءَلة الذي ورد ذكر في "تقرير روما" سنة 1992، أي قابلية الحكام لتحمل المسؤولة عن أعمالهم، وذلك يقضّي إيجاد جوّ من الشفافيّة، تسهّل إتخاذ القرارات الصائبة. لتأمين حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم المسؤولون عن النقابات المهنيّة والعمليّة، وأهل الحكم، فتجعلهم يقبلون التخلي عن مواقع المسؤولية عند إرتكابهم الأخطاء في ممارسة الحكم وإتخاذ القرارات.
والواقع أن هذه المبادئ أقرتها المجتمعات القديمة، وعملت على تنفيذها، وشكَّلت دائماً اهتمام كبار الفلاسفة، والإصلاحيين، واتفقت مع مضامين الكتب االدينية المقدسة التي نصحت بالعدالة والإنصاف.
ولعل أهميّة هذه المبادئ" فيما لو طبقّت، أن تدفع إلى تفادي تدهور العام الحاصل في أساليب الحكم الوطنية والدولية، وتزايد النزاعات الأهلية والإقليمية وزيادة الفقر والفساد، بالرغم من البحبوحة، والتقدّم الصناعي، والعلمي الكبير، وكل ذلك يساهم في تطوير المفاهيم الأخلاقية والقانونية، والإقتصادية في الدول المتقدمة التي يمكن إختصارها "بعلم الإقتصاد والسياسي". وهكذا، فلا بد للتنميّة إذا ما اريد لها أن تكون "مستدامة" من أن تتضمن مبادئ الإنصاف، وحسن الإدارة، والتضامن بين جميع الفئات الإجتماعية للحفاظ على البيئة، والموارد الطبيعية، وعدم تراكم المديونية، وتحميلها للأجيال الطالعة، وتوزيع الموارد العادلة من النمو، وعلى كل الفئات الإجتماعية، الوطنية منها، والعالمية.
ونصل الآن إلى أسباب قصور السياسات المتبعة في تحقيق التنمية البشرية، منفرض تعدادها على الوجه التالي:
1- الفصل بين سياسات الإستثمار، اهداف التنمية البشرية في الخطط الإنمائية.
وفي ذلك إشارة أساسية إلى ضرورة ربط هاتين الفئتين من الخطط، بصورة وثيقة وكذلك ربطهما بسياسات الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وحفظهما من النضوب بسرعة، وبسياسات حماية الفئات السكانية ذات الدّخل المتدني وغير المستقر.
2- محدودية تأثير الأنفاق على القطاعات الإجتماعية.
وهي ما يجب أن تواجهه بصورة قاطعة، بسياساتٍ ترمى إلى تعميم الخدمات الإجتماعية، التربوية منها، إضافة إلى الخدمات التكنولوجية.
وفي ذلك ما يرفع مستوى معدّل الأعمار، ويخفّض معدّل الوفيات (وفيات الصغار بصورة خاصة)، ونسبة عدد الأُميين ونسبة عدد السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر المطلق، أي على أساس دولار واحد إلى دولارين (6% في البلدان العربية و15% في شرق آسيا، و28% في أميركا اللاتينية).
3- أسباب الإخفاق في توطين التكنولوجيا الصناعية وقطاع الالكترونيات.
رغم الإنفاق على التربية، وهو ما جعل التوسع الكميّ في النظام التعليمي غير متوافق وغير موافق للتقدم النوعي. فانتاج مراكز البحوث العلمية العربية مثلاً، لا يكاد يبلغ 2% مما يمثله في الولايات المتحدة الأميركية وهي نسبة لم تتبدل منذ ثمانينات القرن الماضي وسط عالم يشهد تغيرات تقنيّة سريعة جداً.
4- الكلفة العالمية لتحسين مستوى التغذية
ذلك ان إمدادات السعرات الحرارية اليومية، تسجل تقدّماً عالمياً في العديد من الدول النامية (2200 – 3200 وحدة حرارية للشخص الواحد في اليوم الواحد).
ولكن هذا التقدّم لا يأخذ بالإعتبار تكلفة السياسات التي أدّت إلى هذا التحسّن، بل لم يترافق مع نسبة عالية من الحفاظ على البيئة، والموارد المانية، ونوعية وخصب التربة الزراعية والأسمدة المستخدمة والآيلة إلى تخفيض جودتها، وتلويث المياه والبيئة بصورة عامة.
ولا بد من الإشارة أن الدول العربية، بما فيها لبنان، تشكو من إنخفاض نسبة الأمن الغذائي، وبخاصة المواد الغذائية الأساسية، ومنها الحبوب، والزيوت، واللحوم، والحليب ومشتقاته ...
أين نحن في لبنان بالنسبة للتنمية المستدامة؟
في الواقع لم تدخل عبارة " التنمية المستدامة" آداب لبنان الاقتصادية حتى الآن. ذلك ان ارساء دعائم التنمية المستدامة في لبنان، تتطلب سياسات إقتصادية كلية مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في المقاربة التنموية التقليدية.
ويقتضي بأن تتناول السياسات الجديدة أعمال القطاعين العام والخاص في الوقت عينه، لإدخالهما في إطار مبادئ التدبير والمساءَلة.
غير أن نجاح هذه السياسات تفترض شؤوناً مؤسساتيّة مسبقة تذهب للإنتقال إلى قيم جديدة يتّفق عليها، وهي قيم التعاضد والعدالة والإنصاف، ودعم الرأسمال البشري والمجتمعي. وذلك يتطلب بأنّ تكون الأولوية لتقوية المجتمع المدني، وإعادة النظر في البنية القانونية، والبنية الأساسية، المؤسساتية لتأمين تناسقها مع المبادئ والقيم التي تستند إليها التنمية المستدامة ...
فما هي هذه الشروط المؤسسية؟
إنّها تكمن بالدرجة الأولى في تقوية هيئات المجتمع المدني من خلال تأسيس آليات تنموية تؤمن الإستمرارية والتكامل من خلال فتح مجالات الحوار بين السلطات وهيئات المجتمع المدني.
وإذا كان هنالك من نشاطات متواصلة وحكيمة على صعيد النقابات وهيئات المجتمع المدني من شأنها الإهتمام برعاية الطفل، وبحقوق المرأة، أو بالحفاظ على البيئة، أو باحترام حقوق الإنسان، فإن هذه النشاطات وإن كانت تساهم في نشر الوعي الذي يعتبر أحد مكونات "التنمية المستدامة"، فإنه يتطلب ليكون هذا الوعي منتجاً وفاعلاً بأن تفتح الدولة حوارات بناءَة مع تلك الهيئات فتغيّر في ضوئها، مجرى السياسات التنموية التقليدية لتتماشى مع التكيِّف الهيكلي المفروض من قبل هيئات التمويل الدولية التي أصبحت أكثر إنفتاحاً على متطلبات التنمية المستدامة.
وما يجب الإعتراف به هو أن الإصلاحات الموجودة لا يمكن بأن تتم من دون مشاركة فعالة من المجتمع المدني على إختلاف هيئاته. فموارد الدولة باتت محدودة، وأجهزتها بحاجة إلى إعادة النظر في حجمها ومهامها، وطرق عملها، كما أن شعور الإنتماء الوطني، والولاء للدولة لدى أفراد المجتمع لا يمكن بان يترسّخ دون مشاركته الحرّة والديمقراطية على مختلف مستويات الحياة العامة، سواء على صعيد حق الإنتخاب في المجالس الإنتخابية النيابية منها، أو البلدية أو غيرها ...
ولعل تنشيط مشاركة المواطنين في الحياة البلدية هو من الأهمية بمكان أساسيّ. فالمشاركة على الصعيد الوطني لا تتم في غياب المشاركة الديمقراطية على صعيد المجتمع المدني. فأجهزة الدولة المركزية لا يمكنها متابعة أمور الحياة المجتمعية، بالجديّة المطلوبة. فيما الإدارات المحلية هي قريبة من الناس ومن همومهم ومشاكلهم ويمكنها بان تتحسَّس، وتبادر إلى معالجة المشاكل المتعلقة بالبيئة، أو بالنظام التربوي أو الصحي، التي يعاني منها جمهور الناس الفقراء في المناطق الريفيّة بصورة خاصة.
ولا شك بأن تنشيط الحياة البلدية يتطلب المزيد من الموارد للإنفاق على التنمية المحلية، وسدّ ثغرات السياسات المركزية، وذلك من خلال مساهمة الدولة من جهة ومساهمة أبناء المناطق اللامركزية، عبر نظام ضريبي خاص، من جهة ثانية. وإلى جانب مشاركة هيئات المجتمع المدني والأجهزة البلدية والمحلية، لا بد من تنمية البيئة القانونية لدى المواطنين لأنها تساهم بصورة أساسية في إرساء دعائم "التنمية المستدامة".
والتقدم الإقتصادي عينه، لا يمكن أن يتم بصورة واضحة خارج الإطار القانوني في الحياة السياسية والمدنية، وذلك من خلال المبادرات الإقتصادية وتطوير الشركات والمؤسسات الإنتاجية. فالأنظمة الرأسمالية في الدول المتقدمة لم تتطوّر إلاّ عندما طورت المفاهيم القانونية فمكنت الأفراد من تأمين حقوقهم، وأوضحت قواعد الممارسة الإقتصادية بطريقة شفافة هادئة إلى تحسين تعادل الفرص بين جميع العاملين.
وعليه فلا بد من النصوص القانونية الواضحة ووضعها في متناول المواطنين، والسّهر على تطبيقها بصورة متجانسة، والعمل على تطويرها أخذاً بالحسبان التقدم الحاصل في الميادين الإقتصادية والعلمية والمالية والبيئية، ومكافحة الفساد والإحتكار، وحقوق الملكية الفكرية وتنظيم الأسواق المالية، وتدريب الموظفين والقضاء على الإجراءات القانونية الحديثة في هذا المجال.
إن تأمين العناصر الثلاثة التي أوردناها، وهي مشاركة المجتمع المدني، وتقوية اللامركزية، بتنشيط الحياة البلدية، وتطوير البيئة القانونية والقضائية والتنظيمية هي من العناصر الجوهرية التي لا بد منها لإرساء دعائم التنمية المستدامة لا شكّ بأن غياب هذه العناصر من شأنه أن يعزز الإختلالات، والإختناقات المختلفة التي من شأنها أن تقضي على الأمل في تحقيق التنمية المستدامة، وآثارها المرجوة والإيجابية لا في الحاضر فقط إنما أيضاً في المستقبل.
ولا بد من الإشارة إلى أهمية رفع مردودية القطاع العام الذي يعاني الآن من مؤشرات غير مرضية، سواء على صعيد التنمية البشرية، أو على صعيد البنى التحتية، والى أنَّ ذلك يستدعي من الأجهزة الحكومية والقطاع العام بذل أقصى الجهود لإعادة النظر في أوجه الإنفاق، وطرق إستخدامه، بإعادة النظر في سلم الرواتب، وعدد الموظفين، وذلك يستدعي التركيز على دراسة دقيقة في المجالات التربوية والصحية والإجتماعية بصورة عامة، لرفع إنتاجية الإنفاق العائد لهذه المجالات ...
ومن الطبيعي ألاّ نهمل وجه الإنفاق العلمي، بخاصة فيما يتعلق بالأبحاث العلمية التطبيقية في الدول النامية، ومنها لبنان، لأن ذلك يساعد في تحسين مقاربة القطاعات الخدماتية والإنتاجية والصناعية وبخاصة الزراعية، لإتصالها بالأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، والتأقلم مع التطوير المستمر، على أصعدة مراقبة الجودة والتقيد بمعايير الإنتاج والتسويق وبراءات الإختراع ...
إن ذلك يستدعي أخيراً زيادة فاعلية القطاع الخاص بتنظيم أوضاعه المهنية القطاعية وتسهيل حصوله القروض الضرورية وبتوسيع رقعة أعماله، بالحوار والتوافق مع مؤسسات القطاع العام، ودراسة الأنظمة الضريبية المتوافقة والمشجعة للقطاع الخاص، بتصويب سياسات الإعفاء الضريبي وإلغاء الحمايات غير المبرّرة، ومكافحة الرشوة، والفساد ومحاسبة الذين يقفون وراءهما.
لقد ذكرت البيئة في هذا العرض أكثر من مرة، ولكن ذلك كان دون الأهمية التي يجب إعطاءَها لهذا العنصر الخطير الذي يتوقف عليه، لا التنمية بمعاييرها التقليدية القديمة، ولكن أيضاً بطابعها الإستدامي والإستمراري، وعلاقتها الوثيقة بمستقبل الأجيال المقبلة ولا أغالي إذا قلت بإستمرار البشرية بصورة مطلقة وقد سبق للدكتور رامي زريق مدير برنامج العلوم البيئية في الجامعة الأميركية في بيروت الذي ترأس الفريق اللبناني المشارك في تقرير الأمم المتحدة (G.F.D.4) الذي عقد في بيروت سنة 1999 بحضور أربعماية خبير، وراجعه ألف خبير في شتّى أنحاء العالم. لقد سبق للدكتور زريق أن ربط هذا التقرير بالتنمية ورفاهية الإنسان والبيئة باعتبارها الحاضن لكل الأنشطة البشرية وتشكل حمايتها واستدامة توازنها وتنميتها أساس استمرار الإنسانية أي على أساس "التنمية المستدامة" بمعناها الحديث والخطير.
ولكن ما الذي تعنيه التنمية المستدامة بجانبها البيئي على وجه التحديد؟
إننا نحاول أن نشير إلى أهم مضامينها تعداداً، لا حصراً، بالنظر إلى لائحتها الطويلة، التي يزداد عدد أركانها يوماً بعد آخر.
إنّها التلوث بالدرجة الأولى، وتبلغ نسبته في لبنان خمسة أضعاف المسموح به عالمياً، والتلوث المتداول هو تلوّث للنفايات الناجمة عن النشاطات البشرية، بقطع النظر عن مكانها، وزمانها، وكميتها، أمياهاً كانت إذا ما أضيفت إلى التربة بكميات تحلّ فيها محلّ الهواء، أو أملاحاً تتراكم في الأراضي الزراعية، بسبب قصور نظام الصرف، أو نفطاً متسرّباً إلى مياه البحار، أو أصواتاً تزداد شدّتها عن حدٍّ معينٍ، فتزعج كل موجود حيّ، وهناك، بالإضافة الى هذه الملوّثات، تصبح كلها ملوثات. "التلوث المعنوي" الناتج عن الدعايات العصرية التي تشير بالوصول إلى الشهرة، والأرباح المالية، باستخدام جميع وسائل المختلفة: السرعة، العنف، الخلاعة، الجنس إلخ ... كما ويعتبر تلوثاً أيضاً كل ما يخلّ بالتوازن العقلي كالمخدرات، والمكسرات، والضجيج.
ولكن لنركِّز على التلوث الحقيقي، وهو يشتمل على:
1- تلوث الفقراء: ويعني مليارات البشر، الأغنياء منهم، ومتوسطي الحال، وبخاصة الفقراء، وبصورة أخصّ الجياع الذين يقدر عددهم بحوالي مليار نسمة، وهو إلى إزدياد مستمرّ بالرغم من جميع المؤتمرات، والقرارات، والجهود الدولية.
ومن أهم أسباب هذا التلوث:
- "الكائنات الحيّة" الناقلة للأمراض (اليفوئيد، والكوليرا، وبيوض الديدان، ...)
- الجراثيم الحية التي تحوّل المواد الغذائية الى سموم غذائية...
- الفئران والذباب التي تنقل الملوثات إلى غذاء الإنسان، وتسبب له الأمراض، خصوصاً في الأوساط الفقيرة التي لا تستطيع الحصول على الكهرباء بصورة مستمرة للحفاظ على الأطعمة.
- المبيدات الكيماوية التي تستعمل لوقاية المزروعات وتنتقل إلى جسم الإنسان عبر تناوله المواد الغذائية والحيوانية.
- المواد الكيماوية الحافظة بعد أن يفوت تاريخ صلاحيتها، فتصبح مضرّة للإنسان ...
- المعادن الثقيلة السامة كالزئبق، الذي يدخل بالعادة جسم سمك البحر وينتقل منه إلى جسم الإنسان، متحولاً إلى زنبق عضويّ بعد أن يكون لا عضوياً (المثيل الزئبقي السام وكلوريد الزنبق المثيلي). وهو ما يحصل من خلال استيراد أسماك أو صيد أسماك أو من خلال حبوب معالجة "باوكسيد الزنبق".
- " المواد المشعّة" التي من شأنها أيضاً أن تلوث الغذاء بعد أن يتساقط غبارها الذريّ على النباتات والتربة، أو بعد تلويثها للهواء والماء، وإنتقالها عبر سلاسل الغذاء، إلى الحيوان، والإنسان.
2- تلوث الهواء: وهو المادة التي يحتاجها الإنسان كما يحتاجها كل موجود حيّ (كلمة نفس وتنفس. وكلمة ريح وروح ... وهما من جذر واحد) وذلك بكمية تفوق عشر مرات كمية المياه التي يشربها الإنسان. ولقد ذكر تقرير توقعات البيئة في العالم (G.E.O.4) الذي أطلق برنامج الأمم المتحدة تحت عنوان "البيئة من أجل التنمية" ان أكثر من مليار شخص في آسيا بات معرضاً لمحتويات تلوث الهواء ما يسبّب الوفاة المبكرة لحوالي 500 ألف شخص وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية. إنّ تلوّث الهواء يتم عبر:
- الجزئيات الصلبة المتعددة المصادر والتي يمكن بأن يكون نشؤها حجرياً كالرمل، او معدنياً كالنحاس، أو من أملاح الحديد، والرصاص والزئبق إلخ ... أو من أصل نباتي كالقطن، والخيوط، والطحين، وسواد الدخان، عندما تهب الريح فتتطاير معها جزئيات هذه المواد، ويصل الخفيف منها إلى مسافات بعيدة جداً، بينما تتساقط الجزئيات الكبيرة قرب مصادرها. أما الجزئيات الصغيرة فتتبدّد في الهواء، وتتجمع أحياناً فيما بينها، فتمتص بخار الماء، ينتج عنها ستار رقيق من الغيوم. وكلما إزداد إزدحام السكان، كلما إزدادت كثافة الجزئيات والميكروبات في القاعات والمعارض والسينمات، والشوارع الصغيرة، وليس من عدوٍّ لها إلاّ الطرقات الواسعة والمنازل المحاطة بالأشجار والخضار.
- الغازات الجوية: التي تتصاعد من المصانع ومداخن المنازل، وتعتبر أهم مسببات تلوث الهواء. وهي تزداد بازدياد حركة التصنيع ومن هذه الغازات غاز الكبريت، الذي يتفاعل مع أوكسيجين الهواء، فيتحول إلى قطرات من حامض الكبريت المضر جداً، كما يتلف النبات والأبنية الأثرية والثياب عند ملامستها، وهو ما تؤكده المقارنة بين المصابغ في المدن وفي الأرياف.
- دخان الإحتراق غير الكامل في أفران المصانع ومحركات السيارات. ودخان المصانع (مصانع الورق، والمعادن، ومصافي البترول. والصناعات التجارية ومحطات الطاقة الذرية، ومعامل الترابة والكهرباء) هو أسود رقيق يتصاعد فوق المدن الصناعية فيرهق الإنسان، والحيوان، ويحجب اشعّة الشمس الضرورية لنموّ الأطفال.
- أما دخان السيارات فهو يلوث الهواء بغاز أول أوكسيد الكاربون السام، وثاني أوكسيد الكاربون الخانق واكاسيد الآزوت، والهيدروكاربونات، التي يؤدي إلى تدمير البيئة، وتلف الأشجار، أكثر من الأمطار الحمضية التي ذكرناها أعلاه ...
- وفيما يختص بالضجيج، الناتج بالعادة عن المواطن القليل الذوق، والذي تتجاوز حدّته المستوى العادي (الكسارات، والحفارات، والجرافات، والمولدات الكهربائية، إضافة إلى التفجيرات وديناميت الصيد ...) فينتج تأثيراً سيئاً في السمع والأعصاب والقلب والمعدة والأحوال النفسية، سرعة الغضب، ضعف القدرة على التفكير، وإرتفاع نسبة إفراز الغدد االتي تسبب بارتفاع نسبة السكر إلأخ ...
ولا بد من الإشارة إلى آفة التدخين التي انتشرت في العالم بدءاً باوروبا، بعد انتقال زراعة التبغ الأميركية بواسطة الفاتحين الاسبان، فبلغ مقداره أوائل العقد الأخير من القرن الماضي، حوالي 4500 مليار سيجارة، (ثلثها في الصين Quid 1991) ولقد قدرت الدراسات والإختبارات العديدة كما ذكر في تقرير المعهد الطبي الملكي في لندن، بأن "من يدخن سيكارة واحدة يومياً يخسر خمس سنوات من عمره" بسبب النيكوتين، ويصاب بارتفاع الضغط، وكمية الكولستيرول، وتقلّص الشرايين، وتصلبها، والذبحة الصدرية، والسرطانات على إختلافها، والضعف الجنسي، ... وذلك ما حمل الحكومات في بعض دول العالم الى منع التدخين، في الطائرات، والمطاعم، والأمكنة المغلقة، تحاشياً لاثاره المميتة.
3- تلوث الماء: أي المادة التي لا غنى عنها في حياة الإنسان، بالرغم من توفرها (4،1 مليار كيلومتر مكعّب في العالم)، حيث تقدّر المياه العذبة في حدود 0.8 % من هذا المجموع، ويتمّ توزيعها نسبٍ غير متساوية بين دول العالم. وفيما تحدث فيضانات شديدة في أميركا الشمالية، نرى بان أواسط القارة الأفريقية تعاني من العطش والجفاف الحاد. ما يؤدي إلأى خسارات كبيرة في الأرواح البشرية وفي اعداد المواشي، وحجم الغلال.
ومن الطبيعي بان تتواجد الكثافة السكنية العالية إلى جانب مصبات الأنهار والسواقي أو قربها، وذلك ما أدّى ويؤدي إلى إنخفاض نقاوة المياه العذبة، وحتى نقاوة مياه البحيرات والبحار، بسبب التلوث الناتج عن مخلفات النفط المطروحة في البحار، وبخاصة في البحر المتوسط.
1- فمخلفات المصانع ترمى في مياه الأنهر أو في البحر مباشرة، دون تنقية فنية، فينتج عنها تلوثات كيماوية عديدة مثل الكبريت والزنبق ومركباته والنحاس والرصاص والتوتيا وغيرها...، التي تكمن خطورتها في انتقالها إلى النبات والحيوان، والإنسان عبر السلاسل الغذائية، ما يؤدي خصوصاً بالنسبة للزنبق ومركباته إلى ارتخاء تدريجي في العضلات وفقد البصر، والغيبوبة والموت.
وتنجم أكثر الملوثات عن مصانع الرصاص والنحاس، والزئبق، والتوتيا، والدباغات، والمسالخ، ومعامل تعقيم الألبان، وتكرير السكر، ومصافي البترول التي تستخدم كمية كبيرة من مياه التبريد، والسفن الساخرة عباب البحر، والبحيرات، والأنهار، والتي تترك وراءَها الزيوت والفضلات المحترقة والتي تشكِّل طبقة رقيقة عازلة على سطح المياه، تمتد على مساحات شاسعة، وتمنع تجدد الأوكسيجين. في المياه ما يتسبب بإختناق الحيوانات والنباتات المائية.
وقد ساهمت المبيدات والأسمدة الكيماوية في تلويث المياه من خلال جرف الأمطار والسيول إما إلى المياه الجوفية وإما الى الأنهار والبحار، ناقلة معها النتريت والنيترات والأمونيا كأملاح الفوسفور، ومركبات الكلور الضارّة التي يستغرق تفككها سنوات عديدة.
2- أما فضلات المجاري والنفايات الناتجة عن النشاطات البشرية اليومية، فإنها تشكل بدورها مصدراً آخر لتلويث المياه والروائح الكريهة وتسببها بتغيب عديد من الديدان وكل أنواع الجراثيم الممرضة.
3- وإذا كانت الحكومات تلجأ في بعض الدول الى إستخدام مطهرات ومواد مبيدة للحشرات، فإنها تكافح الملوثات بملوثات أخرى، ربما كانت أشدّ ضرراً. لأن معظمها لا يتفكك بسهولة ما يهدد صحة الإنسان في طعامه وشرابه، وربما في حياته ... وذلك ما يحدث في لبنان حيث يوجد 15 مصب للمجارير في العاصمة لوحدها، أما النفايات في المدن والقرى الأخرى ففي مجاري الأنهار ومنها الى البحر وجزء منها الى الطبق الارتوازية.
4- النفط الملوث وتقدّر كمياته المطروحة في المحيطات والبحار بأكثر من 15 مليون طن سنوياً نتيجةً لاعمال النقل، وكوارث الناقلات، وتطبيقها، واستخراج النفط والغاز الطبيعي. وقد لوحظ بأن الأسماك المصطادة في الشواطئ، تكثر فيها فضلات النفط، تعرف بكره طعمها، كما لوحظ بأن هنالك كميات واصنافاًكبيرة من الأسماك تبيدها هذه الفضلات. وقد قدر بان ليتراً من النفط يستهلك كمية الأوكسيجين الموجودة في 400 ألف ليتر من المياه ...
5- لا بد من الملاحظة بأن البحر الأبيض المتوسط دُعي منذ مدة بأنه "صندوق قمامة العالم" ما حمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى عقد مؤتمر دولي في مدينة "برشلونة الإسبانية" سنة 1975، نتج عنه ما عرف "بشرعة برشلونة" التي تتضمن خطة وضعت بالعاجل آنذاك، لإنقاذ البحر الذي يتلقى 90% من فضلات ونفايات ما لا يقل عن 140 مليون إنسان، يعيشون على ضفافه. ومنها الكيماويات السامة، ونفايات المعادن، ومنها الزئبق، وغيره من العناصر الثقيلة الخطرة، التي تتسبب بالكثير من الأمراض التي تنتقل من طريق سلاسل الغذاء؟
6- تلوث التربة وهو ناتج بصورة رئيسية عن مبيدات الأعشاب والحشرات والفطريّات، التي بالإضافة إلى وظائفها الأساسية، تقتل الكائنات الحية التي توجد في التربة، وتحلل موادها العضوية. هذا إلى جانب استخدام الأسمدة بصورة غير علمية، ممّا يؤدي إلى تلوث التربة، وانقراض الغابات، ما يحدث خللاً كبيراً في التوازن الطبيعي للبيئة، فيقضي على فضائل الطيور والحيوانات، ويعرّي التربة، ويسلب خصوصيتها، مع الإشارة إلى أن مساحة الغابات التي تنقرض في العالم، واسعة جداً، وقد بلغت حوالي أربعة ملايين فدّان في دول أميركا الوسطى.
وإلى جانب التلوث بأشكاله المقدرة التي ذكرناها هنالك التغيرات المناخية التي تعتبر من أبرز التحديات العالية وذلك في مجال الغلاف الجويّ والتنوع البيولوجي والمياه.
ولقد أشار تقرير البيئة من أجل التنتمية حول توقعات البيئة العالمي تحت عنوان "البيئة من أجل التنمية" إلى أن هنالك دليلاً واضحاً لآثار تغيير المناخ، وتوافقاً في الرأي على أن الأنشطة البشرية كانت حاسمة في حدوث هذا التغيير، وإن متوسط درجة الحرارة في العالم ارتفع بحوالي 0.74 درجة منذ عام 1906، وإنه من المتوقع بأن يرتفع خلال القرن الحالي بين 1.8 و4 درجات مئوية. وهو أمر خطير جداً بالنسبة للقرى والمدن والقرى المتواجدة على الشواطئ البحرية، نتيجة لذوبان الجليد في المحيط الشمالي، الذي من شأنه أن يرفع مستوى مياه البحار، ويهدد باجتياح هذه المياه لتلك المدن والقرى.
ولا ننسينَّ الخسارة في الانتاج الزراعي العالمي، وبالتالي تعرّض البشرية للمجاعة، كما ذكر في تقريري الإجتماعين اللذين عقدا في نيويورك، وفي روما، خلال شهري شباط وحزيران من سنو 2008، فلفت على أثر أحدهما مسؤول البنك الدولي السيد روبير زوليك إلى احتمال حصول "الجوع الأكبر". فالمساحة القادرة على تأمين المواد الغذائية تقدر بحوالي 22 هكتار للشخص الواحد، في حين أن القدرة الإستيعابية لكوكب الأرض تتراوح بين 15 و16 هكتار للشخص الواحد، ويشير تقرير (G.E.O.4) المذكور أن هنالك إختلافاً كبيراً "للبصمة البيئية" بين الدول في مختلف أنحاء العالم وحتى بين الدول داخل الإقليم الواحد.
وتقدر الخسارة في الإنتاج العالمي الإجمالي من جراء آفات الحشرات بنحو 14% ويتسبب استخدام الأراضي غير المستدام في تدهورها، وهو تهديد في خطورة المناخ، ونفاد التنوع البيولوجي، وفي ذلك ما يؤثر على حوالي ثلث سكان العالم من خلال التلوث وتآكل التربة وندرتها ونضوب المغذيات، وندرة التربة، والتسلح، واضطراب الدورات الأحيائية. فحوالي 90% من خدمات النّظُم البيئية التي جرى تقويمها تعتبر متدهورة أو تستخدم بطريقة غير مستدامة إضافة إلى أن ثلاثة ملايين نسمة يموتون سنوياً في البلدان النامية بسبب الأمراض التي تنقلها المياه، معظمهم دون الخامسة من العمر، ويقدر أن 2،6 مليار نسمة يفتقرون الآن لخدمات الصرف الصحي، ويتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بنسبة 50% سنة 2025، في الدول النامية، و18%، في الدول المتقدّمة.
وبعد،
ماذا فعلنا نحن لحماية بيئتنا الطبيعية؟
لا شك بأن إنشاء وزارة للبيئة في لبنان منذ حوالي عقدين من الزمن، هو خطوة إستراتيجية للتوجه نحو الرقي النشود.
ولكن الجهود المبذولة حتى الآن هي متواضعة جداً، سواء على صعيد هذه الوزارة، أو على صعيد الجمعيات البيئية التي تعتبر بمعظمها جمعيات متوسطة المستوى الحرفيّ، مع انها تستحقّ التقدير والتحية والإحترام.
لقد أتينا في الجزء الأخير من هذه الدراسة على ذكر تلوث الغذاء. فهل نحن ساهرون بالفعل على مراقبة البيدات والأسمدة الكيماوية على اختلافها وعلى تطايقها مع الأنظمة والتوجهات العلمية المتبعة في العالم لحماية المنتوجات الغذائية، والتربة، والمياه الأرتوازية.
وهل بدأنا مع الدول المتوسطية في البحث عن طريقة لمعالجة المعادن الثقيلة التي يتسمم بها البحر الأبيض المتوسط ...
وهل تابعنا مسألة النفايات الصناعية الخطرة والسامة التي أودعت الحوض الخامس سنة 1987، والتي أخرج منها حوالي 6000 برميل وبقي منها حوالي عشرة آلاف برميل فقامت قيامة جمعية خبراء الخط الأحمر اللبنانية التي أكّدت بأن هذه النفايات كلف ادخالها إلى لبنان عشرات الملايين من الدولارات، وبقي منها في لبنان حوالي عشرة الآف برميل من أصل ستة عشرة ألف، وراح خبراؤها يبحثون عنها ليجدوا عدداً بسيطاً من البراميل في مجرى نهر إبراهيم، وأعالي جرود كسروان، كما وجدوا براميل فارغة في بلدات عكارية، ومنها تكريت، والبرج، وجبرايل والجوقة. وقد تبين بأنها تحتوي على مواد كيماوية شديدة الضرر (بالدرجة /6/) كما اشار الخبير الدكتور جوزف فارس.
وهل قمنا بمراقبة سلامة الهواء الذي يحتاجه الإنسان، كما يحتاجه كل موجود حي فأشرفنا على الممكن من هذه المراقبة، وبخاصة فيما يتعلق بالغازات الجوية التي تتصاعد من المصانع ودخان ومحركات السيارات، والكسارات وغيرها؟.
وهل حاولنا إبعاد الآلات والأعمال المتسببة بالضجيج الذي ينتج تأثيراً سيئاً في السمع، والأعصاب، والقلب، والمعدة إلخ؟...
وهل قمنا بواجبنا لتحذير المواطنين من آثار التدخين الذي تشجّع الدولة على استيراده لما يجنيه من ضرائب سهلة التحصيل؟
وهل أخذنا الإحتياطات الضرورية للحدّ من تلوث الماء، وهي المادة التي لا غنى منها في حياة المواطنين والتي إذا لم تتم مراقبتها، كانت نتائجها وخيمة على الإنسان، والحيوان، والنبات، وبالتالي المواد الغذائية، والتي من شأنها ان تلحق بالمواطن أضراراً فادحة ؟
كلها أسئلة تتطلب أجوبة سريعة في معالجتها مع الإعتراف بالعوائق التي تعترض هذه المعالجة سواء المالية منها أو التقنية، والخارجية منها والداخلية، ولكنها معالجة حتمية، ولا بد منها، لإتصالها بحياة المواطن ليس في الوقت الراهن وحسب، وإنما أيضاً بالنسبة للأجيال الطالعة التي ترمي التنمية المستدامة لحمايتها على أكثر من جبهة وفي أكثر من مجال.
ولد نبيه غانم في بلدة صغبين بالبقاع الغربي، واتم مراحل دراسته من الابتدائية حتى الثانوية في مدرسة الفرير في الجميزة.
حاز غانم على 3 شهادات جامعية، فنال شهادة الهندسة الزراعية من المعهد الزراعي الوطني في غرينيون بفرنسا، كما نال اجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف في بيروت، اضافة الى شهادة دبلوم الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة القديس يوسف ايضا.
شغل غانم عددا من الوظائف الادارية في لبنان وخارجه، بحيث تسلم رئاسة ادارة الثروة الزراعية في لبنان من العام 1958 حتى العام 1964 ، ورئاسة مصلحة زراعة البقاع من العام 1964 حتى العام 1970، ومن ثم رئاسة مصلحة التعاون في البقاع من العام 1973 حتى العام 1992، واخيرا تم تعيينه مستشارا لمجلس ادارة بنك بيروت للتجارة من العام 1992 حتى العام 1997.
كما عيّن غانم مندوبا للبنان لدى منظمة الدراسات الزراعية العليا لدول البحر المتوسط من العام 1980 حتى العام 1993، ونائباً لرئيس المنظمة نفسها من العام 1984 حتى العام 1986.
الى جانب الوظائف الادارية، عمِل غانم في مجال التدريس الجامعي، فعمل كأستاذ محاضر بمادة الاقتصاد في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية من العام 1978 حتى العام 1995، وكأستاذ محاضر بمادة الاقتصاد في كلية الزراعة بجامعة القديس يوسف من العام 1978 حتى تاريخه، اضافة الى تدريسه مادة الاقتصاد الزراعي في كلية الصيدلة في الجامعة اليسوعية منذ عام 2003 حتى تاريخه. كما عمِل غانم كأستاذ زائر بمادة الاقتصاد،في معاهد الدراسات الزراعية العليا في "" ايطاليا ، "" اليونان، و"" فرنسا، خلال فترة عضويته في منظمة الدراسات الزراعية العليا لدول البحر الابيض المتوسط من العام 1985 حتى العام 1993.
للدكتور نبيه غانم مؤلفات كثيرة منها، المشكلة السكرية في لبنان عام 1966، الزراعة اللبنانية وتحديات المستقبل عام 1972، التسليف الزراعي في خدمة التنمية عام 1984، الزراعة اللبنانية بين المأزق والحل عام 1998، مشروع قانون الزراعة عام 1996، خطة "التنمية الزراعية" للبناني عام 2009، و مشروع بحيرة الليطاني السياحي.